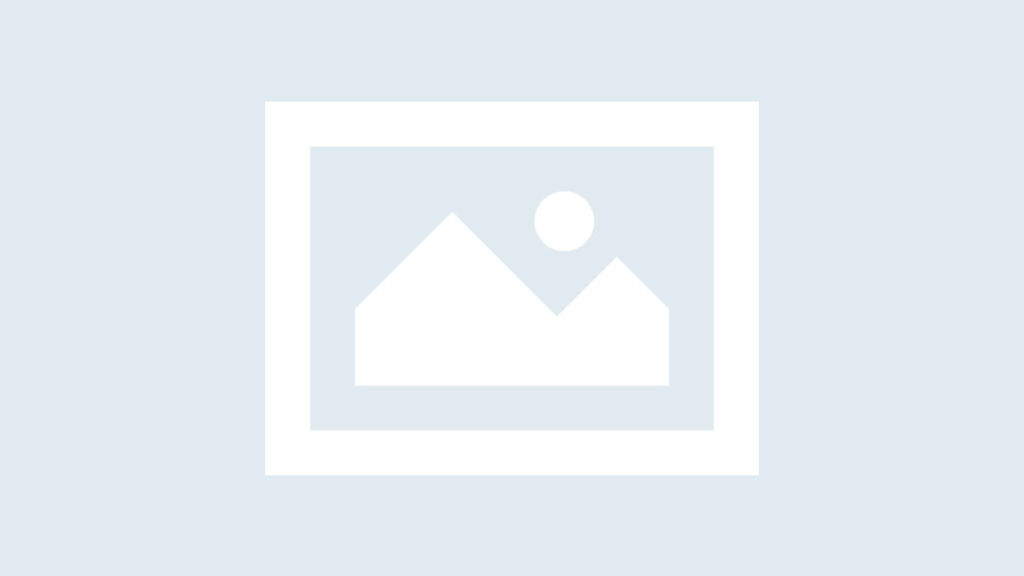” نريد دولة تُعزّز فيها قدرات الخزينة المالية…” ـ هكذا تعهّدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري عام 2025. لكن بين سطور هذه الوعود، يقف واقع أكثر تعقيدًا وهو أن نصف الاقتصاد تقريبًا يعمل خارج رقابة الدولة، محرومًا من الجباية والضرائب، ومليئًا باستغلالٍ للعمال لا يجد من يحميه. هنا، يتبدّى التناقض بين الخطاب الرسمي وبين حقيقة اقتصاد الظل الذي يتمدّد على حساب الخزينة والمجتمع.
بدأ الاقتصاد الخارج عن رقابة الدولة بالتوسّع في لبنان مع اندلاع الأزمة المالية، حين أدّت تقلبات سعر الصرف وتراجع قدرات الدولة إلى تراجع فعالية الرقابة على الأسواق. فبحسب البنك الدولي، بلغ حجم الاقتصاد الموازي في لبنان عام 2015 نحو 2.8 مليار دولار (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهي أعلى نسبة مسجلة قبل بداية الأزمة.
ومع تعمّق الأزمة وتراجع قدرة الدولة على الرقابة وارتفاع معدلات البطالة، اتجه عدد متزايد من الشباب، خصوصاً غير المؤهلين منهم، نحو أعمال غير مصرح عنها. وبدأ الاقتصاد غير الرسمي يتحوّل تدريجيًا من هامش محدود إلى أحد أعمدة النشاط الاقتصادي.
بحسب البنك الدولي، قفز حجم الاقتصاد غير النظامي في لبنان إلى 4.5 مليار دولار عام 2020 (14.2% من الناتج المحلي)، ثم إلى 9.86 مليار دولار عام 2022، ما يُمثّل 45.7% من الناتج المحلي. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعكس أيضاً تراجع الناتج الرسمي خلال الأزمة.
هذه الأرقام يمكن أن تفسر باتجاه شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود نحو القطاع غير الرسمي لتأمين احتياجاتهم.. فمع تآكل القدرة الشرائية وانهيار قيمة العملة، لم تعد الوظائف كافية لتغطية تكاليف المعيشة، فكان اللجوء إلى الأعمال غير المصرّح عنها خيارًا شبه إجباري، في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي فاعلة.
وتُعد الاستثمارات غير النظامية من أبرز تجليات اقتصاد الظل، حيث تعمل مؤسسات كثيرة بدون تراخيص أو إفصاح للدولة. ووفق البنك الدولي، تُشكّل هذه المؤسسات ما يقارب ثلث القطاع الخاص، ما يعكس حجم الاقتصاد الخارج عن الرقابة.
تعمل هذه الكيانات في الظل، فتُخفي أرباحها وتتفادى التصريح عن موظفيها، ما يحرم الدولة من إيرادات ضريبية كان يمكن استثمارها في التعليم، الصحة، النقل، والبنى التحتية. ويُعتبر هذا الاقتصاد بيئة خصبة لاستغلال العمال، إذ تشير التقديرات إلى أن 62.4% من القوة العاملة في لبنان يعملون دون تصاريح، وغالبًا ما يتقاضون أجورًا متدنية، دون تأمين صحي أو ضمان اجتماعي.
ورغم أن هذا النشاط يُدخل أموالًا إلى السوق، إلا أنه يخلق منافسة غير عادلة للمؤسسات الملتزمة بالقوانين، ويُضعف الأسس التي تُبنى عليها الدولة الحديثة. فالضرائب التي يتم التهرب منها هي المصدر الأساسي لتمويل الخدمات العامة.
هنا تكمن ضرورة تقليص حجم اقتصاد الظل، من خلال إصلاح النظام الضريبي. فالضرائب المرتفعة وغير العادلة تُعد من أبرز أسباب اللجوء إلى السوق الموازية. وفي لبنان، يُظهر النظام الضريبي اختلالًا كبيرًا: الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11% تُثقل كاهل الفقراء، بينما يتهرّب الأثرياء من دفع حصتهم.
من جهة أخرى، يلعب التصوّر العام حول فعالية الدولة في استخدام الضرائب دورًا مهمًا. وهذا ما عبر عنه أحد أصحاب المشاريع الصغيرة غير المصرح عنها في بيروت:” لماذا أدفع الضريبة للدولة ان كنت لا أستطيع الوثوق بأن هذه الضريبة التي أدفعها ستعود بالنفع علي وعلى عائلتي؟ “
فحين يفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة، يُصبح أقل ميلًا لدفع الضريبة. وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن 80% من اللبنانيين لا يثقون بالحكومة، و72% لا يثقون بالقضاء.
إن اقتصاد الظل في لبنان أصبح يستحوذ على حصة كبيرة من الناتج المحلي اللبناني، وهو أحد الأسباب الأساسية لاستغلال العاملين وتدني مستوى أجورهم. لذلك على الحكومة الاهتمام بإصلاح النظام الضريبي، وتحقيق العدالة من خلال ضرائب تصاعدية تطال أصحاب الثروات، وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي.
اقتصاد الظل في لبنان لم يعد مجرد هامش، بل تحوّل إلى قاعدة تهدد استقرار الدولة الاجتماعي والمالي. فإذا أرادت الحكومة استعادة الثقة، فلا يكفي رفع الضرائب أو إطلاق الوعود، بل المطلوب عدالة ضريبية تطال أصحاب الثروات، وشبكات أمان اجتماعي تحمي الأضعف. فبينما يتّسع الظل يومًا بعد يوم، يضيق هامش الدولة في البقاء.
- مدرس مادة الاقتصاد
المصدر: بريد الموقع